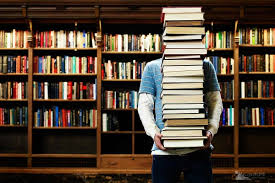“عم أحمد مات”.. جملة اخترقت قلبي، حين أبلغنا الصيدلي أن مساعده الأربعيني قد توفي، الرجل الطيب الذي كان يقابلني بابتسامة كلما مررنا بالصيدلية، لم يعد موجودًا، لم تجمعني بالرجل سوى كلمات بسيطة، مع ذلك تعجبت من تأثري الشديد بوفاته، قد يكون السبب أن وفاة الرجل مثّلت لي الاحتكاك الأول مع حدث الموت، لم أفهم وقتها كيف مات! كان عم أحمد أول شخص أعرفه يموت، تجربة لم تكن سهلة برغم سطحية العلاقة.
أزمة قلبية أجهزت على قلب الرجل المسكين. كنت في الصف الثالث الابتدائي حينها، حاولت أن أفهم أكثر عن هذا الحدث المقبض، لكن شيئًا لم يشبع فضولي، وقتها صادفت كُتيِّبًا يُفتَرض أنه ديني على الرصيف يتحدث عن الموت، لمؤلف سبق اسمه بـ”شيخ”، لكني عرفت بعدها بفترة أنه ليس أكثر من مؤلف “بير سلم”، وأن الكتيب ما هو إلا مطبوعة غير مُرخَّصة لشخص لم يحصل حتى على درجة جامعية.
تخيلت أن ثمة إجابة داخله؛ سارعت بدفع مصروفي ثمنًا له، لأُجهِز عليه في المنزل، لكن الكاتب المجهول لم يأن جهدًا في تحويل فكرة الموت إلى أمر مفزع للغاية، وبدلاً من أن يشرح ما جاء بالفعل في صحيح الدين حول مسألة الموت، أخذ يهوِّل ويتحدث عن أمور مُرعبة، حتى وصل الأمر به إلى التأكيد بأن جميع البشر مُخطئون وسيصيبهم العذاب الأليم بالضرورة، دون أدنى حديث عن الغفران أو الرحمة أو العدل أو حتى تناسب العقاب مع الجُرم.
اكتملت المأساة مع جارنا الصعيدي الذي جاءه والده المُسن من قريتهم بالصعيد إلى شقته بالجيزة، بغرض العلاج، إلا أن الإهمال الطبي الشديد أودى بحياة الرجل، الذي مات على مهل وسط أفراد الأسرة، لكن الأمر لم يتم بسلام على الإطلاق.
“أبو شوقي بيطلَّع في الروح بقاله أسبوع”.. جملة اخترقت رأسي بعنف، ترددتْ في أرجاء البيت كي ينزل الجيران من أجل مواساة الرجل وزوجته، كان باب منزلهم مفتوحًا، دخلت بصحبة الأطفال الذين ملؤوا الشقة الصغيرة، لأرى المشهد الذي لن أنساه ما حييت، الرجل العجوز الممدد، يرغي فمه المفتوح لا إراديًا، وجههه الأصفر وعيناه السارحتان في عالم آخر، هذا كله وسط أحاديث المحيطين عن أن قدمه قد ماتت بالفعل، والكثير من الكلام الذي عرفت أيضًا فيما بعد أنه لم يكن سوى تجويد من الموجودين، فالرجل الغائب في عالمه كان يُحتَضر فعلاً، لكن كل أحاديثهم عن انسلال الروح ببطء، وشعوره الشديد بالعذاب لم يبدُ منطقيًا لي فيما بعد، إذ كيف يتعذب فاقد الوعي؟!
سنوات طويلة قضيتها مع رعب شديد من لحظة الموت، حتى أنني عجزت عن النوم لشهور، حيث تملكتني فكرة أنني إذا نمت قد ينهار المنزل فوقي، أو يخنقني أنبوب البوتجاز، أو تحرقني نيران قد تندلع في أي لحظة.
بالرغم من كل ما سمعته وقرأته فيما بعد عن مدى بؤس تلك الكتيبات والأفكار السائدة عن تلك اللحظة الحتمية، لكن قلبي ظل مقبوضًا منها كالكثيرين، إلى أن قابلت “ماركوس أوريليوس”، الإمبراطور الروماني والفيلسوف الرواقي، الذي قدم خلاصة أفكاره ومبادئه في كتاب بعنوان “التأملات”، قرأته لأجدني أتحرر فجأة من كل تلك العقد والأفكار المرعبة.
توفي “ماركوس” عام 180 ميلاديًا، عن عُمر 59 عامًا، على جبهة الحرب، وكانت آخر كلمات كتبها قبل موته “أيها الإنسان الفاني.. لقد عشت مواطنًا في هذه المدينة العظيمة، ماذا يهم إذا كانت هذه الحياة خمسة أعوام، أو خمسين؟ على الجميع تسري قوانين المدينة، فماذا يخيفك في انصرافك من المدينة؟ إن من يصرفك ليس قاضيًا مستبدًا أو فاسدًا، إنها الطبيعة ذاتها التي أتت بك، إنها أشبه بمدير الفرقة الذي أشرك ممثلاً كوميديًا في الرواية وهو يصرفه من المسرح.
– لكني لم أمثل مشاهدي الخمسة، مثلت ثلاثة فقط.
– حقًا، ولكن في الحياة قد تكون ثلاثة مشاهد هي الرواية كلها.
من ركَّبك في أول مرة هو الذي يفنيك الآن. ما لك من دور في أي من العلتين؛ اذهب بسلام إذًا، فالرب الذي يصرفك هو في سلام معك”.
وجهة نظر ماركوس التي عكسها طوال الكتاب جعلتني أتصالح مع ذلك الحدث، فالموت بحسب ماركوس “ما الموت؟ إنه وظيفة طبيعية، ومن يرتاع لوظيفة من وظائف الطبيعة سوى طفل غرير؟!”.
وجهة نظر تتضح أكثر مع تلك الجملة التي لم أنسها قط، والتي أجابت عن سؤال بشأن من فارق الحياة بين هؤلاء الذين يموتون مبكرًا، وهؤلاء الذين يُعمِّرون طويلاً، يقول ماركوس: “حتى لو قدر لك أن تعيش ثلاثة آلاف عام، أو عشرة أضعاف ذلك، فاذكر دائمًا أن لا أحد يفقد حياة سوى تلك التي يحياها، او يحيا حياة سوى تلك التي يفقدها.. أطول حياة وأقصرها سيان. اللحظة الحاضرة واحدة في الجميع، ومن ثم فإن ما ينقضي متساوٍ أيضًا. الفقدان إنما هو فقدان لحظة لا أكثر، فالمرء لا يمكن أن يفقد الماضي ولا المستقبل، إذ كيف يفقد ما ليس يملك؟!”.
في النهاية أصبحت أعيش مع تلك القناعة التي زرعها داخلي ماركوس، والتي جعلت ألمي وهلعي تجاه الموت والموتى تتلاشى كثيرًا، إذ أن ما يسلب من المعمر هو ما يسلب من أقصر الناس عمرًا، فليس غير اللحظة الحاضرة ما يمكن أن يسلب من الإنسان، لم أعد أتألم لوفاة شخص لأنه شاب، لم تعد فكرة “ده لسه صغير” تراودني، صالحني الفيلسوف المحارب على الفكرة إلى حد بعيد، صحيح أن ثمة تساؤلات ما تزال بقلبي، لكنني بالتأكيد لم أعد أرتجف كلما تذكرته كما كانت الحال في طفولتي.